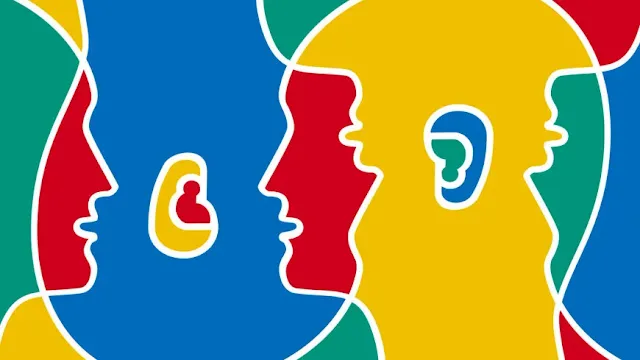آخر حصون الأندلسيين.. لغة «الألخميادو» السرية
سقطت غرناطة سنة 1492، فطُويت بسقوطها آخر صفحة من تاريخ الحكم الإسلامي في الأندلس. بالرغم من توقيع المسلمين على معاهدة تضمن لهم حرية الممارسات الدينية والحفاظ على الهوية الإسلامية والتقاليد الأندلسية وعلى ممتلكاتهم، وأموالهم، ولغتهم، وزيهم، وشعائرهم، وغيرها من البنود التي تضمن للمسلم عيشًا كريمًا في ظل الحكم الكاثوليكي؛ إلا أنه سرعان ما نُقضت.
مارست السلطات الكاثوليكية ومحاكم التفتيش ضغطًا على المسلمين للتخلي عن الإسلام، واعتناق المسيحية، والتحدث بالقشتالية بدل العربية وغيرها من الانتهاكات التي تهدف إلى طمس الهوية الإسلامية الأندلسية؛ فَخُير المسلم سنة 1501 بين التحول للمسيحية أو الطرد والنفي خارج أرض الوطن.
وفي ظل هذا القرار قرر هؤلاء «المسيحيون الجدد» ممارسة الإسلام خفية، ونصرة البقية الباقية من تراثهم، وثقافتهم، وهويتهم باللجوء لاستعمال لغة «الألخميادو» السرية (أو عجمية الأندلس)؛ فدوَّنوا بها كل ما يتعلق بالإسلام. وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللغة لم تظهر بعد إصدار قرار التنصير، وإنما ظهرت بوادرها الأولى قبل تلك الفترة.
كيف نشأت الألخميادو؟
نشأت لغة الألخميادو، حسب الدكتور علي الكتاني، في القرن الرابع عشر بين مدجني مملكتي أراغون وقشتالة، واندثرت في القرن الثامن عشر، فكان عمرها حوالي 400 سنة تقريبًا.

مخطوط بلغة الألخميادو السرية عُثر عليه سنة 1988 داخل جدار منزل في بلدية نوفاياس (بالإسبانية: Novallas) وهي بلدية تقع في مقاطعة سرقسطة التابعة لمنطقة أراغون شمال شرق إسبانيا
تعتبر لغة الألخميادو، في مفهومها الضيق، لغة رومانية قشتالية كُتبت بأحرف عربية. وبالتالي فالأدب الذي دُوِّن على هذا النحو يسمى بأدب الألخميادو.أما في مدلولها الأوسع فهي مجموع اللغات الرومانية، من بينها الإسبانية والمستعربية أو المستعربة، المرسومة بخط عربي.
إن تدوين هذه اللغة بحروف عربية يعكس رغبة هؤلاء الكتاب في التعبير عن الانتماء لعقيدة الإسلام الجماعية. لقد أدرك المورسكيون (المسلمون الذين بقوا في إسبانيا تحت الحكم المسيحي بعد سقوط الأندلس وخُيروا بين اعتناق المسيحية أو الطرد) أن الذي يفقد لغته العربية يفقد أيضا دينه. لذلك استعملت اللغة الألخميادية المورسكية أبجدية القرآن تعبيرًا عن الارتباط الثقافي والروحي بالأمة الإسلامية.

نظام كتابة الألخميادو، تعتمد لغة الألخميادو نسخ اللغة الرومانية القشتالية بأحرف عربية وذلك بمبادلة كل حرف روماني قشتالي بحرف عربي يُعتَبَرُ الأقرب إليه من الناحية الصوتية في محاولة للتوسط بين المنطوق والمكتوب.
لا زال هذا الأدب محفوظا في مكتبات إسبانيا، ومعدودا من النوادر. نشأ اهتمام كبير بدراسة وتحليل وفك رموز وثائق ومخطوطات أدب الألخميادو في نهاية القرن التاسع عشر من طرف بعض رواد هذا المجال مثل باسكوال غيانغوس، وإدواردو سابيدرا. وفي مطلع القرن العشرين برزت أسماء أخرى مثل: خوليان ريبيرا ومغيل اسين بلاثيوس. حظيت الدراسات الألخميادية في الحقبة الأخيرة باهتمام أكبر من طرف مختصين مثل آربي، مرسيدس غارسيا أرينال، مانويلا مانثناريس دي ثيرِّي وبشكل خاص من طرف اللغوي والمستعرب الإسباني آلبارو غالميس دي فوينتيس (1).
نعتقد أن هؤلاء الكتاب الذين ابتكروا هذه الكتابات ذات الطابع المختلط والتراجيدي والمُرَكَّب يستحقون أن يحظوا بمكانة مميزة ضمن ما يسمى بأدب العصر الذهبي الإسباني، الذي وبكل تأكيد، ينتمون له. إننا أمام كتابات تعكس أهمية تاريخية بالغة. وتتجلى هذه الأهمية في توثيقها لألم ومعاناة شعب قاوم طمس الهوية والاندثار، وبذل جهدا جبارا لإيقاف مصير تاريخي حتمي (2).
أصل كلمة ألخميادو
يُطلق على الأدب المورسكي الذي دَوّن اللفظ الروماني بحرف عربي اسم «ألخميا» أو «ألخميادو»، والكلمة من أصل عربي وتحيل على لفظ «أعجمية» أو «عجمية» أو «أعجمي» والجمع «عجم» و«أعاجم». ويطلق لفظ «أعجمية»
في اللغة العربية على كل لغة غير عربية. ويكثر استعمال مصطلح «أعجمي» مرادفًا لـ«أجنبي» في إحالة على الشخص غير العربي أو الشيء المَنْسُوبِ إِلَى الْعَجَمِ أو مَنْ يَنْتَمِي إِلَى بِلاَدِ الْعَجَمِ. ويسمَّى أعجمي أيضًا مَنْ لا ينطق بالكلام الفصيح ولو كان عربيًّا. ويُقال لسانٌ أَعجميٌّ أي غير عربيّ، كتاب أَعجمي: كتاب غيرُ مبين، لفظ أعجميّ: لفظ دخيل أو غير فصيح. ويُقال رَجُلٌ أَعْجَمُ أي رَجُل لا يُحْسِنُ النُّطْقَ بِاللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ وَلا يُفْصِحُ، ولايُبَيِّنُ كَلامَهُ وَإنْ كانَ عَرَبِيًّا (3).
وبالتالي تبنى المسلمون لفظ أعجمي (أجنبي) أو أعجمية (لغة غير عربية) في لفظ «ألخميا» أو «ألخميادو» للدلالة على اللغة الرومانسية أو الرومانية القشتالية التي شكَّلَت لغة المُحتَل الأجنبي. يتعلق الأمر بمزيج فريد من اللغتين العربية واللاتينية العامية (الرومانسية). ونتحدث عن نص ألخميادو إذا ما كتبت الصوتيات اللاتينية بالأبجدية العربية، ليكون الألخميادو إذن لغة رومانسية منحدرة من اللاتينية انفردت بطريقة كتابتها بحروف عربية؛ ولفظا استعمل عموما في إسبانيا لتعيين التكافل الذي كونته كل من العربية واللغات الرومانسية، التي كانت شائعة في شبه الجزيرة الإيبيرية.
ظروف نشأة أدب الألخميادو
ظهرت أولى بوادر أدب الألخميادو، حسب المستعرب والمترجم الإسباني مغيل دي إيبالثا (1938 – 2008)، في قشتالة القديمة بعد بضع سنوات من فتح القسطنطينية (1453)، وبالضبط حوالي سنة 1460 يربط إيبالثا ظهور الألخميادو بظاهرة تدوين بعض كتاب شعوب أوروبا المسلمة إنتاجاتهم الأدبية بلغتهم الأم، مستخدمين في ذلك، الأبجدية العربية. كما يربط ظهور أدب الألخميادو كأدب مُفَسِّر للإسلام بظاهرة أخرى ألا وهي ظاهرة هجرة فقهاء وعلماء أندلس القرن الثالث عشر، الشيء الذي ولَّدَ رغبة واهتماما بتخليد الخطاب الديني في نصوص تمزج اللاتينية بالعربية.
يرى بيرنابي أن أدب الألخميادو يتميز عن غيره من اللغات الرومانية بنظام الكتابة الفريد، الذي يهدف إلى الحفاظ على التراث الإسلامي. شكلت اللغة العربية بالنسبة للمورسكيين رمزا دينيا قرآنيا مقدسا، ومرجعا أساسيا، لمقاومة سياسة التثقيف القسري، وعنصرا رئيسا لإثبات انتمائهم للمجتمع الأندلسي بشكل خاص، وللمجتمع الإسلامي بشكل عام. لذلك أدرك المورسكي جيدا أن كل ابتعاد عن اللغة العربية هو بمثابة ابتعاد عن الإسلام، وهكذا، ومن هذا المنطلق، نشأت ضرورة استعمال الأبجدية العربية.
أما باتريك آربي فيعرض مبادرة يوحنا الشقوبي «خوان دي سيغوبيا» (1393-1458) كسبب آخر وراء ظهور ونشأة أدب الألخميادو. كان يوحنا الشقوبي لاهوتيا إسبانيًّا، من أهل أشقوبيه وقسًا في طليطلة. بعد تركه الحياة العامة واعتزاله في أحد الأديرة، قضى الكثير من وقته باحثا عن كيفية تحقيق تفاهم خطابي بين الثقافتين: الإسلام والمسيحية. وَكَّل مهمة ترجمة القرآن للفقيه الأندلسي المسلم عيسى بن جابر الشقوبي، لكن الترجمة ضاعت. وهكذا ساهم يوحنا الشقوبي، حسب باتريك آربي، بشكل هام في ربط اللغتين الرومانية القشتالية والعربية. تطلع من خلال هذه الترجمة ومن خلال كتاباته إلى تحقيق تفاهم خطابي بين الفكرين الإسلامي والمسيحي. اهتم بدراسة القرآن، وبالتعرف على الطقوس والتقاليد الإسلامية بهدف البحث عن أنجع وسيلة لتحويل المدجنين للمسيحية. إلا أن هذا الربط بين اللغتين، بالنسبة لباتريك آربي، كان سببا وراء ظهور هذا الأدب. فبالنسبة لهذا الباحث، إن تلك الشخصية التي ربطت بين الثقافتين واللغتين بحثا عن إيجاد أنسب وسيلة لتحويل المدجنين للمسيحية ساهمت للمفارقة وبشكل متناقض في ظهور أدب الألخميادو(4).
ومن جهته، يرى خيسوس ثانيون أن أدب الألخميادو شكل مادة تعليمية وتربوية، جاءت تلبية لحاجة المورسكيين، خاصة الأراغونيين منهم، لتعلم اللغة العربية.
رواد أدب الألخميادو
بدأ هذا التقليد مع القشتالي عيسى بن جابر الشقوبي، مفتي وفقيه جامع شقوبية وكنيته أبو الحسن. انتشرت كتاباته لاحقا عبر فتى أريبالو (كاتب قشتالي موريسكي من القرن السادس عشر). ساهم الشقوبي في النهوض بالترجمة وتطوير الفقه في إسبانيا والفن المدجن. هو أول من ترجم القرآن للقشتالية بطلب من الكاردينال يوحنا الشقوبي. ويعود تاريخ هذه الترجمة لما بين ديسمبر 1455 ومارس 1456. يرى آربي أن عيسى بن جابر سيكون، على الأرجح، أول مبتكر لنظام تدوين النصوص الإسلامية بلغة الألخميادو. ودُون رفض هذه الفرضية، يرى إيبالثا أن عيسى بن جابر لعب دورا هاما في تقبُّل المدجنين لهذا الأدب، وذلك لكونه أول من ترجم نصا مقدسا (القرآن الكريم) للغة عامية (الرومانية القشتالية)، خاصة أن ظاهرة الكتابة بلغة الألخميادو تبدت مباشرة بعد هذه الترجمة. ومن جهة ثانية، ساهم عيسى بن جابر في تطوير الفقه من خلال تأليف أول عمل فقهي مدون بلغة الألخميادو سنة 1462 «المختصر في السنة». ويؤكد إيبالثا عدم وجود أي نص قبل هذه السنة. استهدَفَ المؤلَّف بالدرجة الأولى الساكنة المدجنة التي ظلَّت عن علم شيوخها وعلمائها. ويتطرق العمل لمعالجة قضايا متنوعة من فقه العبادات مثل: الطهارة، والصلاة، والحج.
ويحتل فتى أريبالو مركزا مرموقا في الكتابة الألخميادية. وهو مورسكي من آبلة يتمتع بإبداع أدبي كبير. أُجبِرَ على اعتناق المسيحية. يعتبر ثاني أكبر مؤسس لأدب الألخميادو. ينحدر من أريبالو (بلدية تقع حاليا في مقاطعة آبلة التابعة لمنطقة قشتالة وليون وسط إسبانيا). يرى إيبالثا أنه مؤلِّف فريد في مجال أدب الألخميادو الموريسكي. تعكس كتاباته إحاطة عميقة باللغة الرومانية وغنى خاصا على مستوى المضمون والمعجم وقدرة إبداعية هائلة وثقلا لغويا. عزا إيبالثا هذا التمكن اللغوي وهذا الغنى الفكري لتواصله الدائم بالتيارات الدينية للمجتمع الإسلامي الغرناطي. سافر بكثرة لغرناطَةَ ما بعد الاحتلال الكاثوليكي في بداية القرن السادس عشر. نقل الألخميادو من قشتالة إلى أراغون، مما أدى إلى اكتساب هذه اللغة للعديد من الألفاظ الأراغونية الدخيلة. لعبت هذه الشخصية دورا هاما في تطوير أدب الألخميادو. اقتبس محمد رمضان من كتابات أريبالو شعرا نُقِلَ بعد ذلك مع موريسكيي أراغون اللاجئين بتستور إلى تونس. ويعتبر محمد رمضان أكبر شاعر موريسكي من آراغون وواحدا من أهم الشعراء المورسكيين على الإطلاق. انتهى به المطاف إلى الرحيل بعيدا عن وطنه والنفي بتونس. وبذلك نلاحظ كيف مرت هذه اللغة من مرحلة التقبل الأولى والانتشار في قشتالة ما بين سنتي 1462 و1501 مع أول ترجمة للقرآن من العربية للقشتالية على يد عيسى بن جابر، ثم مرحلة انتقالها إلى آراغون على يد فتى أريبالو، وأخيرا مرحلة انتقالها إلى تونس(5).

مخطوط ألخميادو يعود لفتى أريبالو
إنه لمن المهم التمييز، منذ البداية، بين الأعمال المؤلَّفة في شبه الجزيرة الإيبيرية قبل طرد الموريسكيين من طرف فيليب الثالث سنة 1609 وأعمال أخرى، تم تأليفها بعد هذا التاريخ، خاصة من طرف الجماعات المورسكية التي انتقلت إلى تونس. يبرز ضمن المجموعة الأولى عدة كتاب وشعراء نذكر من بينهم مؤلِّف قصيدة «يوسف». أورد المرحوم الدكتور الشهيد الكتاني في كتاب انبعاث الإسلام في الأندلس بعض أبيات القصيدة والتي تُنسَبُ لشاعر مجهول من آراغون القديمة عاش في القرن الرابع عشر ميلادي. وجاء في افتتاحيتها:
الحمد لله العلي الحق
العزيز الكامل الملك العادل
رب العالمين الواحد الأحد الصمد
الكريم القوي القيوم
هو الأكبر، تعم قوته كل شيء
ولا تخفى عليه خافية في الكون
لا في البر ولا في البحر
لا في الأرض السوداء ولا البيضاء
اعلموا واسمعوا يا أحبائي
ما حدث في الأيام الغابرة
ليعقوب ويوسف وإخوته العشرة

مخطوط من أدب الألخميادو، قصيدة يوسف
تبرز ضمن أعمال المجموعة الثانية، أي الإنتاجات التي ذاع صيتها بعد إصدار قرار طرد المورسكيين من شبه الجزيرة الإيبيرية، المؤلفات الشعرية لمورسكي آراغوني من رويدا دي خالون (بلدية تقع اليوم في مقاطعة سرقسطة التابعة لمنطقة أراغون شمال شرق إسبانيا) واسمه محمد رمضان. تتطرق قصائده الشعرية بشكل عام، لحياة النبي محمد. وفي نفس الحقبة (مطلع القرن القرن السابع عشر) وفي أبيات شعرية أيضا، نظم مورسكي آخر معروف باسم «ألهيتشانتي» من منطقة مونثون التي عرفها المسلمون باسم مُنتشون (في أراغون) شعرا يبرز علاقة المورسكي بالحج تحت عنوان «قصائد الحاج بوي مونثون». مما يوضح أن كثيرا من الموريسكيين سافروا ثم رجعوا إلى بلادهم، ومنهم من حج بيت الله الحرام ورجع (6). كما عُثر على قصيدة مناهضة للمسيحية منظومة سنة 1627 م من طرف مورسكي من ألكالا دي إيناريس (مدينة إسبانية تقع في منطقة مدريد وتعني قلعة على نهر إيناريس). هاجر لتونس ويدعى خوان بيريز أما اسمه الحقيقي فهو إبراهيم الطيبلي. كاتب كبير ومن أهم الموزعين للكتابات التي حررها غيره من المؤلفين. ظهرت في نفس الفترة بعض أعمال الألخميادو التي تدافع عن الإسلام كتلك التي ألفت سنة 1615 من طرف عبد الكريم بن علي بيريز وروايات نثرية تروي السيرة النبوية وحياة الصحابة.
وينقل لنا الدكتور الكتاني في كتاب «انبعاث الإسلام في الأندلس» أبياتا حزينة لشعراء بكوا على ما آل إليه وطنهم من تدمير، ومثال ذلك هذه الأبيات المترجمة من أدب الألخميادو لشاعر مجهول يبكي فيها بلدته الحامة (القريبة من غرناطة) عند سقوطها في يد النصارى:
آه على بلدي الحامة،
الرجال والنساء والأطفال
كلهم يبكون هذه الخسارة العظمى
كما بكت كل سيدات
غرناطة
آه على بلدي الحامة،
لا ترى من نوافذ بيوتها في أزقتها
إلا مأتما كبيرا
ويبكي الملك ما عساه يبكي
لأن ما ضاع كثير
آه على بلدي الحامة
وعبَّر شاعر الألخميادو الكبير علي بيريز، عن القهر الذي عاشه الشعب الأندلسي في قصائد وأبيات نذكر من بينها:
أنا لا أبكي على ما مضى
لأن لا يمكن الرجوع إلى الماضي
ولكن أبكي لما سنرى
من نتانة ومرارة
كل من يفهم
ومن مقتطفات النثر الأعجمي نأتي على ذكر ما قاله الفقيه علي بن محمد شكار الذي يفتتح كتابه بما يلي:
«بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الكريم وعلى آله وسلم تسليما، إن الدعوات التي يدعى بها في الشهور العربية هي التالية: الشهر الأول يسمى محرم، وأول يوم منه هو يوم مهم جدا، وهو من الأيام السبعة عشرة من أيام النبي محمد (ص)…».
طور كتاب الألخميادو أدب القصة باعتبارهل وسيلة بيداغوجية لتدريب الناشئة المسلمة سرا على المبادئ والأخلاق الإسلامية، ومن أهم هذه القصص التي نجت من الضياع: «قصة العصر الذهبي» و«قصة علي والأربعون جارية» و«قصة الإسكندر ذي القرنين». ومن أمثلة الكتب التي كتبت بالأعجمية في العلوم التقنية كتاب إبراهيم المرباش المسمى «العز والمنافع للمجاهدين بالمدافع»، وهو في التقنية العسكرية (7).
كما عُثر أيضا على رسائل خاصة دُوِّنت بالألخميادو ولعل أبرزها تلك التي كتبت مباشرة بعد احتلال غرناطة سنة 1492 من طرف الملكان الكاثوليكيان والتي نشرت تحت عنوان «رسالة أعجمية غرناطية» في مجلة أرابيكا سنة 1954. ويوجد في شعر الألخميادو كثير من الشعراء المجيدين الآخرين مثل إبراهيم دي بلغاد، محمد الخرطوش البياني، وغيرهم. وظل كتاب آخرون مجهولي الاسم بسبب الخطر الذي تتعرض إليه حياتهم على يد محاكم التفتيش.
مراحل تطور أدب الألخميادو
يمنحنا إيبالثا تقسيما دقيقا ومفصلا لمختلف مراحل تطور أدب الألخميادو. يتعلق الأمر بعملية إبداع لغوي رسخت جذورها في الحقبة المدجنة:
مرحلة التأسيس القشتالية (1455-1462): حسب إيبالثا بدأت المرحلة في قشتالة القديمة مع عيسى بن جابر، أول من ترجم القرآن الكريم للقشتالية.
المرحلة القشتالية (1462-1501) : يطلق إيبالثا على هذه المرحلة اسم «القشتالية» نظرا لعدم وجود أي نص ألخميادو في هذه الفترة في شبه الجزيرة الإيبيرية خارج قشتالة. ويعتبر فتى أريبالو الكاتب الوحيد والخاص والمميز لهذه المرحلة.
المرحلة الأراغونية (1501-1525) : مع منع هذا النشاط في قشتالة نُقِلَ إلى أراغون، حيث تقبل أهل أراغون هذه النوعية من النصوص الإسلامية التي اكتست طابعا لغويا أراغونيا خاصا على نحو متزايد.
مرحلة التنصير القسري (1526-1609\1614): تمتد هذه المرحلة من سنة 1526, تاريخ التنصير القسري لأهل أراغون إلى غاية الطرد النهائي (1609-1614). تميزت بصعوبة الحفاظ على مخطوطات الألخميادو السابقة مع تسجيل تراجع على مستوى النشاط الثقافي الموريسكي بشكل عام.
مرحلة النفي: بعد هجرة كُتاب وشعراء أدب الألخميادو إلى شمال أفريقيا، لم يعد لهذا الأدب أي سبب للتواجد والاستمرار في شبه الجزيرة الإيبيرية. انصهرت النخبة الموريسكية المفكرة وكوَّنت وحدة ثقافية ضمن مجتمعات الشعوب المُستَقبِلَة. اتسمت إنتاجات هذه المرحلة، حسب إيبالثا، بإثارة بعض القضايا الجدلية كالتطرق لطبيعة الخالق عز وجل وطبيعة المسيح من باب المقارنة بين الديانتين الإسلام والمسيحية وتوضيح رفضهم لشعائر هذه الأخيرة(8).
أبواب ومواضيع أدب الألخميادو
تتناول معظم وثائق الألخميادو مواضيع دينية أو قانونية (فقه)، ولكن هناك أيضا مؤلفات شعرية عامة ذات طابع مثالي موجب للعبرة، وأعمال نثرية تستمد عمقها من الخيال. إن تقسيم أعمال الألخميادو يعكس تنوعا وغنى على مستوى المواضيع. يمنحنا بيرنابي، معتمدا المعيار الموضوعي والأسلوبي الخلاصة التالية:
نصوص دينية: علوم قرآنية، قرآن، تفسير، تلاوات قرآنية، علم الحديث، قواعد اللغة، خطب، نصوص فقهية ( نصوص فقهية عقائدية- صيغ توثيقية- صيغ عقود- قضايا ثابتة)، أدب تعبدي، معايير الزهد والأخلاق، ابتهالات، نبوءات، سير ذاتية وأسفار، حكايا أخلاقية، قصص أخروية، شعر ديني…
نصوص غير دينية: نصوص لا تتطرق للمواضيع الدينية. وتشمل الكتابات المُعتقدة بالخرافة، والوصفات الطبية والصحية، وغيرها(9).
تمكن من الألخميادو أم فقدان مأساوي لقواعد اللغة العربية؟

مخطوط ألخميادو من أراغون لكاتب مجهول، جزء من النص مكتوب باللغة العربية والجزء الآخر بلغة الألخميادو
يتميز أدب الألخميادو ببساطة الأسلوب والابتعاد عن التكلف ويغلب عليه أحيانا طابع الركاكة في التعبير وإن كانت هناك مخطوطات على قدر كبير من البلاغة. تكمن أهمية هذه الإنتاجات الأدبية، أولا وقبل كل شيء، في مزاياها الإنسانية وقيمتها التاريخية والثقافية. تشكل شهادة مأساوية تراجيدية مؤثرة لشعب قاوم الانسلاخ الهوياتي وإن غدت إمكانياته اللغوية والمعرفية خجولة ومحدودة على نحو متزايد بسبب التثقيف الكاثوليكي القسري.
عند تأمل الكلمات الدينية التقنية التي وردت في نصوص الألخميادو باللغة العربية والجمل العربية القليلة التي تتصدر أو تُنهي، في كل الحالات تقريبا، هذه الوثائق؛ نلاحظ دون أدنى دهشة أن اللغة العربية الفصحى قد سقطت في مستنقع من الأخطاء. كثيرا ما تُنسخ باتباع القواعد الصوتية الخاصة بتدوين الألخميادو. إنه لمن المؤلم فعلا النظر إلى المستوى الرديء الذي انحدرت إليه اللغة العربية الفصحى الخاصة بهؤلاء المورسكيين، خاصة عندما نتذكر أنهم أحفاد وورثة أسماء لامعة مثل ابن زيدون وابن عبد ربه.
ومن بين هذه الأخطاء التي لا تحترم القواعد الصوتية الخاصة باللغة العربية، نذكر على سبيل المثال الخطأ الوارد في مخطوط مكتبة مدريد الملكية رقم 36 32. حيث كُتِبت بعض الألفاظ بشكل خاطئ لا يحترم القواعد الصوتية الخاصة باللغة العربية.
 كما يحمل المخطوط رقم (XLVIII) من مكتبة مركز الدراسات العربية في مدريد، أهمية لغوية خاصة وذلك لكشفه، سواء بالعربية أو الألخميادو، عن نسخ وتقليد صوتي للخطاب والنطق الأندلسي. مثال: نطق لفظ حلال «حلار» باستبدال اللام راء وفقا لطريقة النطق الأندلسية.
كما يحمل المخطوط رقم (XLVIII) من مكتبة مركز الدراسات العربية في مدريد، أهمية لغوية خاصة وذلك لكشفه، سواء بالعربية أو الألخميادو، عن نسخ وتقليد صوتي للخطاب والنطق الأندلسي. مثال: نطق لفظ حلال «حلار» باستبدال اللام راء وفقا لطريقة النطق الأندلسية.
 أخد هذا الفقدان التدريجي للغة العربية يتفاقم إلى أن تحول إلى قاعدة. تحولت الأخطاء إلى قاعدة ومنهج يكتب على نحوه العديد من الكتاب. ويبدو أن البعض لم يجهل فقط طريقة الكتابة الصحيحة، وإنما توقف أيضا عن الإلمام بقواعد اللغة العربية اللغوية والنحوية الأساسية. كَتَبَ الموريسكي أحيانا بلغة عربية تقريبا غير موجودة ولغة رومانسية محدودة. بل تفاقم العجز لأكثر من ذلك، فهؤلاء «المؤرخون» المورسكيون لم يصبحوا عاجزين فقط عن التدقيق الإملائي وإنما أيضا عن إدماج بعض المفردات العربية الدينية التقنية بمفهومها الصحيح بعد أن أتلفوا دلالتها الشرعية(10).
أخد هذا الفقدان التدريجي للغة العربية يتفاقم إلى أن تحول إلى قاعدة. تحولت الأخطاء إلى قاعدة ومنهج يكتب على نحوه العديد من الكتاب. ويبدو أن البعض لم يجهل فقط طريقة الكتابة الصحيحة، وإنما توقف أيضا عن الإلمام بقواعد اللغة العربية اللغوية والنحوية الأساسية. كَتَبَ الموريسكي أحيانا بلغة عربية تقريبا غير موجودة ولغة رومانسية محدودة. بل تفاقم العجز لأكثر من ذلك، فهؤلاء «المؤرخون» المورسكيون لم يصبحوا عاجزين فقط عن التدقيق الإملائي وإنما أيضا عن إدماج بعض المفردات العربية الدينية التقنية بمفهومها الصحيح بعد أن أتلفوا دلالتها الشرعية(10).
إن مفهوم التقية الذي برع الموريسكيون في تطبيقه لدرجة كبيرة، أصبح بالكاد يظهر في نصوص الألخميادو على الرغم من تاريخ المورسكي الحافل بأمثلة اللجوء إليه. يعلق كاردياك على الأمر موضحا أنه عثر على لفظ التقية في نص ألخميادو وقد اكتسب دلالة مختلفة وبعيدة عن المفهوم الديني المركب والمعقد للفظ والذي قام بدراسته في المخطوط رقم (fol.102V) للأكاديمية الملكية للتاريخ (11).
تقلصت اللغة العربية في بعض الحالات إلى مجرد ذكرى شاحبة. فقد الموريسكيون المراجع والإحالات اللغوية المعقدة والغنية بالمعاني والرموز الدينية والصوفية الإسلامية السابقة، لتُترجم كألفاظ قشتالية. أصبح الكاتب المورسكي يقوم بمجهود مثير للشفقة عند تعريف الشخصيات المرموقة كعلماء الدين والصوفيين السابقين؛ إذ كل ما يستطيع فعله الآن هو ذكر الأسماء فقط دون أدنى محتوى فكري حقيقي. مثيرة للأسف الطريقة التي استعرض بها فتى أريبالو وبسط من خلالها، في الوثيقة المحفوظة في المكتبة الوطنية لمدريد تحت رقم res.245، مذهب ابن عربي. لقد كانت الظروف قاسية ولم تكن هناك فرصة للتوقف عند الترف الفكري الخاص بالخطابات الصوفية العميقة والمعقدة. مع احتمال إحاطتهم بالأساس بهذه المعارف، الشيء الذي يعتبر مستبعدا جدا في ظل الأدلة التي تصورها بعض المخطوطات(12).
قدم الموريسكي أحيانا حججا دينية مقتبسة عن المسيحية. هاجم الخطاب الديني المسيحي. انتقد بعض المواضيع الجدلية (التثليث، شخصيتي مريم العذراء والمسيح، الكنيسة، البابوية، أسرار الكنيسة…) في أغلب الأحيان استنادًا إلى حجج مقتبسة عن المسيحية لا الإسلام.
إنه لأمر قد يرد ضمن ما هو إيجابي إذا ما أخدنا بعين الاعتبار قدرة المورسكي على نقد المسيحية بحجج غير غريبة عن المجتمع الكاثوليكي ومن صلب عقيدته؛ للبرهنة للمورسكيين والنصارى على السواء أن الإسلام هو الدين الحق وأن النصرانية دين محرف خاطئ، وردا على سيل المنشورات والكتب الكنسية التي هاجمت بين الأوساط المورسكية الإسلام ومبادئه والقرآن الكريم وشخص النبي محمد.
ولكن يعتقد بعض الباحثين أن الأمر قد يعتبر مأساويا، خاصة إذا ما نظرنا للموضوع من زاوية أخرى، حيث دخل الموريسكي، بالنسبة لهؤلاء، مرحلة فقدان هوية فهو الآن عدو للمسيحية أكثر من كونه مسلما. من المؤكد أن تقديم كُتاب الألخميادو الممارسات الإسلامية أحيانا من منظور «المقارنة» مع ديانة أخرى لأمر مخالف لطريقة العرض التقليدية المعتادة، ولكنه طرح يلائم واقع المورسكي الذي تحمل حصص الوعظ الكنسي والممارسات المسيحية المعارضة لتعاليم الإسلام.
تُحفظ وثائق الألخميادو اليوم في مكتبات إسبانيا باعتبارها تراثا إسلاميًّا فريدا يتيما يجهله الكثيرون. يرمز لمجهود أمة قاومت الانسلاخ الهوياتي وأبت إلا أن تحافظ على دينها. إن كل اهتمام عربي بهذا الأدب سيساعدنا على فهم حلقة شبه مفقودة من تاريخ الممارسات الإسلامية بشكل عام. يعتبر بعض النقاد أن لا علاقة للغة الألخميادو بهوية أولئك الذين يعمرون بيئة جنوب إسبانيا الجغرافية اليوم وأن اللغة ليست سوى ثمرة ماض تاريخي تشكَّلَ بفعل تمازج الأجناس والأعراق؛ بينما يطالب بعض الوطنيين بإقليم أندلوسيا الواقع جنوب إسبانيا باعتبار الألخميادو لغة مُمَيِّزة للشعب الأندلسي المعاصر ومكون سوسيوثقافي مرتبط بماضي الإقليم وحاضره.
سميرة فخرالدين
————————————————–
(1) Crónica de la destrucción de un mundo : la literatura aljamiado-morisca, Luce López-Baralt. P.21.
(2) المصدر السابق. ص 23.
(3) راجع معنى لفظ أعجمي في قاموس المعاني.
(4) The Medieval Spains (1993), Bernard F. Reilly. p. 187.
(5) La literatura aljamiada, aproximación general, Karima Bouras. P.60.
(6) انبعاث الإسلام في الأندلس. الأستاذ الدكتور علي المنتصر الكتاني.ص 196.
(7) المصدر السابق. ص 219.
(8) La literatura aljamiada, aproximación general, Karima Bouras. P.62.
(9) المصدر السابق. ص 63.
(10)Crónica de la destrucción de un mundo : la literatura aljamiado-morisca, Luce López-Baralt. P. 26. 27.
(11) المصدر نفسه، ص 30.
(12) المصدر نفسه، ص 34.